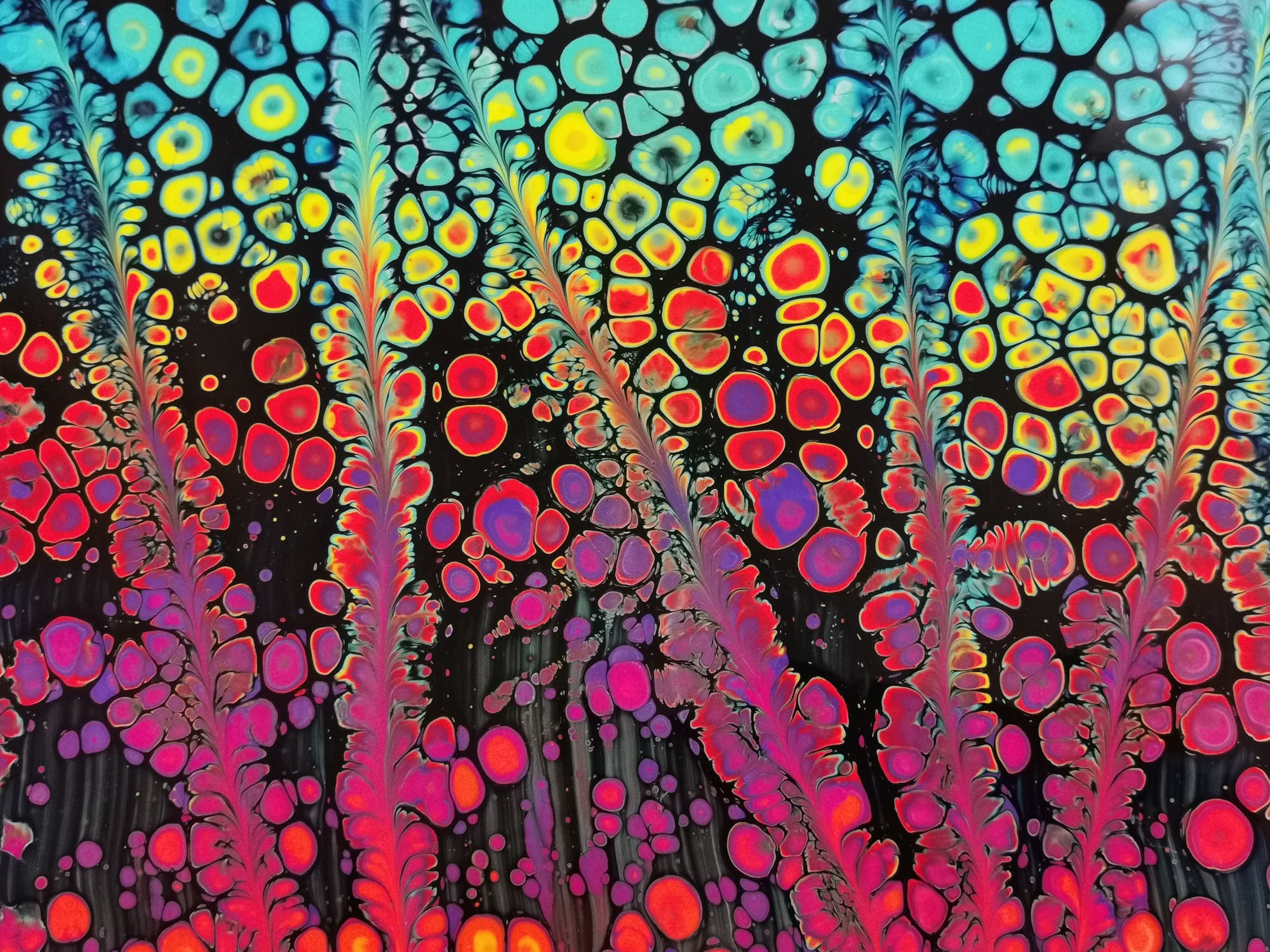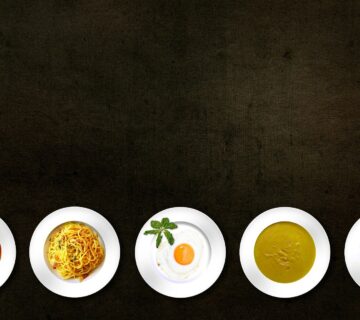تعوّدتُ منذ الصغر أن أرى الدُّنيا مقلوبة رأساً على عقب؛ كانت الوضعية المُثلى التي اعتمدتها للجلوس تتمثل برأس متدلٍ من الكنبة ورجلتين مرفوعتين باتجاه السقف. وبالرغم من مرور سنين طويلة على اعتدال جلستي، إلا أن الدنيا لا تزال مقلوبة، ولكن هذا لا يعنينا الآن. المهم أنني بجلستي هذه كنتُ أحاول أن أقلّد الفنجان الذي كلما فرغ من القهوة كانت تقلِبه جدتي لكي تُحدّثني عن مستقبلها التعيس ومستقبلي الأتعس. كان يتنبأ لنا ذلك الفنجان الكئيب حياة مليئة بالثعابين والصقور والجبال والوديان، الأمر الذي قاد جدتي إلى الانعزال في المنزل خوفاً من صحة التنبؤات التي قد تحرمها من موت رحيم كأن تلقى حتفها في حُفر الصرف الصحي المكشوفة التي كانت مقتنعة أن وديان الفنجان ترمز إليها، أو أن تنهشها قطط الحي السوداء التي كانت ترمز إليها الصقور.
رغم صغر سنّي ورغم سوداوية تحليلات جدتي، إلا أنني كنت استمتع بالقصص التي كانت تحيكها. ولأنني كنت الوحيدة في العائلة التي لم تكبح خيالها بل نمّته، أصبَحتْ فناجين القهوة واستحضار الأساطير المخبأة في قعرها طقساً حميمياً جعل مني الحفيدة المفضلة، وجعل منها الجدة الأعز عليّ.
تعلمتُ من طقسنا هذا أن أحب الرواسب وأُقدّر ما تحتويه من ثقل ونقاء، ما جعلني متأهبة لرصدها أينما ذهبت خاصة خلال رحلة العائلة السنوية إلى البحر الميت. كنتُ أتأمل الصخور الملحيّة التي كانت تُعلن، بنتوءاتها التي كادت تتكلم، نصرها وثباتها أمام الماء الذي جف عنها. كرواسب القهوة، كانت تُخبرني العواميد الملحية قصصاً أمضيتُ ساعات وأنا أرويها إلى جدتي حال عودتنا إلى المدينة.
هكذا أصبحتُ هاوية لقعر الأشياء التي رميتُ أنظاري نحوها علّني أجد ما هو متجذّر تحت زحمة الزخرفات السطحية. كانت هذه نقطة البداية لرحلة بحث طويلة كان الهدف منها أن أجد رواسبي، أن أجد الكتلة التي ستتبقى منّي في حال تبخرّتْ مكوّناتي الأخرى كجسدي أوعائلتي أومجتمعي. لتحقيق ذلك، توّجب عليّ كخطوة أولى أن أحدد المكان الذي تتواجد فيه هذه الكتلة حتى أستطيع بعد ذلك أن أتفحصها وأعرف منها حقيقة من أكون بعيداً عن الأحداث التي جبلتني. رغم سُمعتهما الجيدة في احتواء الذات، إلّا أنني اضطررت أن أستبعد القلب والدماغ كونهما لم يشكلا قعراً أمكنني أن أترّسب فيه على عكس أصابع الأرجل التي كان الحظ من نصيبها.
من هنا بدأتُ أقدّس أصابع أرجلي وأحافظ عليها كما لم أفعل يوماً من قبل، تعاملتُ معها كأنها مسكن روحي الذي سأتلاشى من دونه. قلُمتُ أظافري وطليتها وتعمدّتُ أن أُبقيها مكشوفة طوال فصل الصيف، ومغطاة طوال فصل الشتاء.الآن وكنتُ قد نجحت في تعقّب موقع ترّسباتي كان عليّ أن أستأصلها حتى أستطيع أن أراها، الخطوة التي من أجلها غيرتُ طريقة جلوسي.
اعتقدتُ عندها أنني إذا جلستُ بطريقة مُنافية للجاذبية سأنزلق من قعري كما ينزلق البُن من قعر الفنجان. تارةً تخيلتُني سأنزلق من فمي على شكل سائل لزج زهري، وتارة تخيلتني أتساقط من أذنيّ غباراً أزرق. ورغم أنه لخيبة ظني لم تنجح خطتي، إلا أنني بقيتُ متيّقنة من أنّ الإنسان يكمن في أصابع الأرجل والدليل كان الهلع الذي أبديته عندما علمتُ أن جدّتي ستخضع لعملية بترٍ لأصابع أرجلها التي تفشت فيها الغرغرينا اللعينة. جُننت، واتهمتُ جدتي التي وافقت على إجراء العملية بالاختلال النفسي، وأهلي بالقتل المجحف لتفرُّجهم على الجريمة وهي تحصل على مرأى من أعينهم دون أن تحرّك لهم ساكناً. كنت متأكدة أنّ جدتي ستموت حال قطع أصابعها ولكن لأنّ لا أحد يأبه بمعتقدات أو قناعات فتاة في العاشرة من عمرها، لم يُصغ إليّ أيّ من أفراد العائلة ما أجبرني على التصعيد. لم يكن في اليد حيلة سوى أن أسلّم جسدي وأهواءه عبر اعتصام مفتوح تخلله إضراب عن الطعام والمثول في غرفتي إلى حين التراجع عن العمليّة المُميتة.
بعد ليلة عصيبة أمضيتها لوحدي في الغرفة دون أي طعام سوى وجبَتَي الغذاء والعشاء اللتان مررتلي إياهما صديقتي عبلة خلسة عبر النافذة، دقّت أمي باب الغرفة لتُعلمني أن الفطار جاهز وأنه لم يعد لدي أي سبب أُضرب من أجله لأن البتر قد تم وجدّتي قد نجت. لم أصدّقُها وأجبتُها أنني لن أنساق وراء ألاعيبها وحيلها الماكرة وأنّ إضرابي ما زال مستمراً. بقيتُ مصممة على موقفي إلى أن سمعتُ صوت جدتي ينده اسمي. فتحتُ الباب مُسرعةً إليها فوجدتها رافعة رجليها الملفوفتين بشاش أبيض وابتسامة عريضة مرسومة على وجهها. رحتُ أقبلّها وأعانقها والدموع تنهمر مني بغزارة.
سعدتُ جداً بأنها ما زالت حيّة رغم أن أصابعها قد بُترت، ولكني شعرت بشيء من الخيبة لأن ذلك عنى أنّ الأصابع ليست مسكن الذات. أين هذه الذات اللعينة إذا؟ ألسنا كالبن والملح نترّسب في القعر؟ بدأت أشك بمعاينتي للأمور، هل يُعقل أن أكون قد أخطأت فهم الملح الذي بنيتُ عليه تحليلي؟
اتجهت إلى المطبخ علني أجد بعض الإجابات. وضعتُ ثلاث معالق ملح فوق كوبين من الماء وأشعلت الغاز. تسمرتُ أمام الحلّة أراقب غليان المحلول الذي بدأ يتغيّر لونه إلى البنيّ. ارتبكت. خاصة بعد أن انبعثت رائحة غريبة. هرعت أمي إلى المطبخ تسأل ما الذي يحصل لتجد حريقاً يهب من المحلول الذي أطفأته سريعاً بماء بارد.
كانت الرائحة غريبة ولكن مألوفة، رائحة كراميل. وضعت سكراً بدلاً من الملح!
أيعقل أن نكون سكراً لا ننفصل عن الماء عند الغليان لأنها تكون قد أصبحت جزءا منا ونحن جزء منها، فلا هي تتبخر ولا نحن نترّسب؟