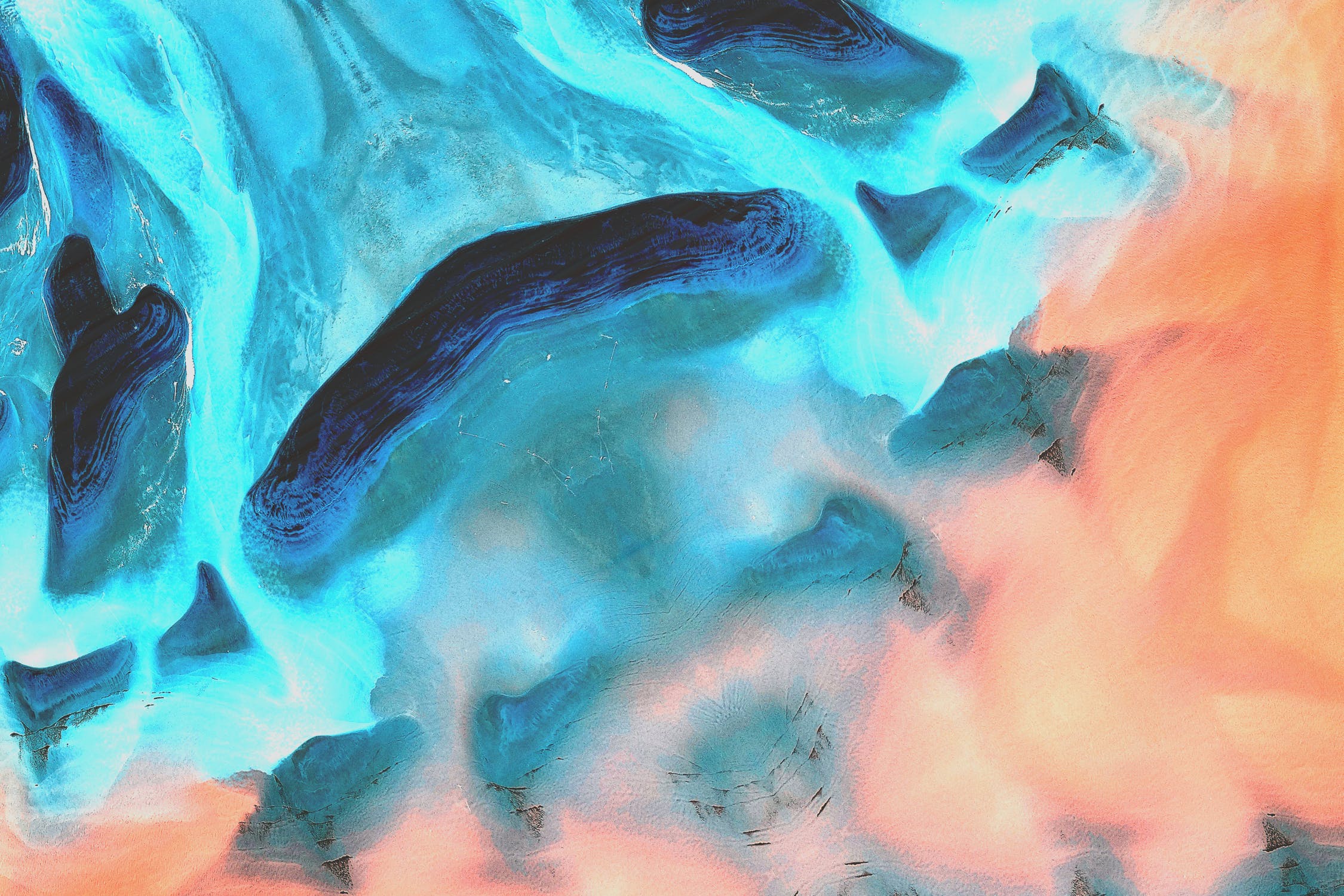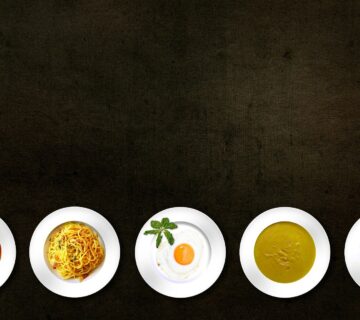الجميع ينتظرُ شيئاً ما. تختلفُ الأشياء، ولكن جميعنا منتظرون.
بينما ينهمكُ الجميع بانتظارِ أشياء مُختلفة، أنتظرُ أنا لحظات انصهار أنانا. أتخيّلُ ذواتنا فقاعات هشّة نحومُ بالفضاء نحو وجهاتٍ مجهولة، نجاهدُ لكي نُبقي أغشيتنا مُحاكة بإحكام لألّا نتبدد. ولكنني أنتظرُ فرقعتنا. تلك اللحظة المُخالفة لغريزة البقاء، الغريزة التي تفرض علينا أن نواجه أي خطر قد يُهدِّدُ أقطارَنا بطريقتين اثنتين لا غير: الكر أو الفر، لا ثالث لهما. الكر أمام المخاطر التي نفوقها قوة كقطرات الندى أو حُبيبات الغُبار، والفرّ أمام المخاطر التي تتفوّق علينا، كأغصان الشجر أو الدبابيس الحادّة. ولكنني أنتظر الاستسلام طريقة ثالثة نكاية. أن نستسلم يعني أن نموت قليلاً وأن نرضى بأن نموت قليلاً يعني أنّ بداخلنا شيئاً يفوق الغريزة، وكل ما يفوق الغريزة يُقرّبني من فكرة أن الله موجود، فأفرح.
كنتُ فقاعةً عندما رأيتُكَ لأول مرة، فتسارَعتْ دقّات قلبي المُحملّة غذاء لكل خلية في جسمي تؤهبني للمواجهة: كر أو فر. لم يوجد طريقة ثالثة تُجنّبُني احتمالية الفقدان، أو الخسارة، أو القهر، أو الخيانة الذين رأيتُهم مُقبلين عليّ بِحُلّةِ “حُب”. إنه خطأ شائع أن نعتبر الفراشات التي ترقص في المعدة خلال هذه الأثناء مؤشراً لمُلاقاة التوأم الروحي، فهي ليست إلا عملية بيولوجية تقينا من أكبر المخاطر التي يُواجهها الإنسان، إنها غريزتنا تتكلم. “سُتحبّينَهُ وسيحبُّكِ ومن ثم سيَموت”. فر. “ستُحبّينَه ولن يحبك ومن ثم سيخونُكِ”. فر. “سيحبُّكِ ولن تحبّيه ومن ثم ستكسرين قلبَهُ”. كر. “سيجتاحُك ويُعنّفُكِ ومن ثمَّ سيغتَصبُكِ”.فر. هكذا تكلَّمَ قُطري الحامي الذي أراد أن يُبقيني فُقاعة متينة أمام حُبِّكَ الذي برزَ أمامي تارة كشوك مُرّ ينقضُّ عليّ، وتارة أخرى كذرّة رملٍ يتوجب عليّ الانقضاض عليها. فر أو كر. لا ثالث لهما.
ولكنني انتظرت. انتظرتُ أن ألين، أن أنسى أناي. وأن أشق لنفسي طريقاً ثالثة قد تُكلّفني ذاتي ولكنها، ولو باحتمالية ١٪، قد تُكسبني العالم بأكمله. كمُقامر ثمل، لم أفعل شيئاً. أنهكني الركض وأنهكتني الحرب، فلم أتحرك. كانت قد تجمهرت الطاقة ببطء في قعري، تَشدُّني إلى أسفل، طاقة ساكنة. لا أدري عندها إن كان شوكٌ قد غرز في أحشائي، أم كانت حبة رمل تركتُها تنمو فوق سطحي دون أن أنقض عليها أظهرتْ أنيابَها الخفيّة وانقلبت ضدي. لا أدري ما الذي حصل، ولكني في لحظة أعجز عن تذكر تفاصيلها، وهو أجمل ما في الأمر، تفرقعت.
هي الفرقعة ذاتها التي أراها تقضي على أُمي كلّما تلت صلاة الزهرة مستسلمة للعذراء ولابنها استسلاماً تاماً. هي مثلي، أنهكها الركض وأنهكتها الحرب، فتَجمد في مكانها وتُصلي. تدع نفسها تسيل نحو إله غير مرئي لا مانع لديها أن تعترف أنها لا شيئ أمامه، وتُصلي. وبينما أنتظرُ أنا لحظة انصهارها مع الكون هذه، تنتظرُ هي شيئاً أبسط، وردة حمراء تُرسلها لها أُم الله: “يا نجمة البحر ساعديني وأريني أنك أمي، يا سلطانة السماء والأرض، إني بتواضع أتضرّعُ إليك من أعماق قلبي لكي تساعديني، أريني بهذا أنكِّ أُمي. وأرجو أن تحصلي لي على علامة الزهرة استجابة لي”.

ولكن هذه ليست اللحظات الوحيدة التي أنتظرها، أنتظر أيضاً لحظات تجمهر أنانا. أتخيلُ ذواتنا فقاعات هشّة انقضّت عليها عاصفة متوّحشة كسرتنا رغماً عنّا، فانقسمت أنصافُنا عن أنصافِها الأخرى حتى باتت أرباعاً، فأسباعاً، فأثماناً، فلا شي. ولكنني أنتظرُ أن نعود شيئاً. تلك اللحظة المُخالفة لغريزة البقاء، الغريزة التي تفرض علينا، لحظة وقوعنا في يد المُفترس، خياراً واحداً لا غير: الانصياع. ولكني أنتظر المقاومة نكاية. أن نُقاوم يعني أن نحيا قليلاً مناكفة بالموت وأن نحيا قليلاً يعني أنّ بداخلنا شيئاً يفوق الغريزة، وكل ما يفوق الغريزة يُقرّبني من فكرة أن الله موجود، فأفرح.
أليس انتظاراً لهذه اللحظة يقف أطفالنا في فلسطين أمام دبابات تفوق سنهم آلاف السنين؟ دبابات مُصرة على أن تُقول لصغارنا أنهم لا شيء، أنهم متشرذمون على هذه الأرض، دون جذور ولا ثمار، أنهم أغصان جافة رُميت بقاياها في جُهنم أو في بلدان بعيدة لا يعرف عنها أحد؟ أليس في سبيل هذه اللحظة قامت عهد، وما زالت تقوم، أمام النار وهي تنقط بالكاز؟ أليس من أجل هذه اللحظة ذاتها تُحارب نساء الأمازون جرافات النفط بأظافرهنّ العارية؟
طالما أنّ بيننا أطفال يُصادقون الحجارة علّهم يُصبحون مثلها، في الوقت نفسه الذي نجد فيه بيننا دراويش يطوفون حول أنفسهم على أمل أن تتلاشى أرواحهم، طالما أننا قادرون على القتال في الوقت نفسه الذي فيه نقدر أن نُحب، أن نتبخر في الوقت نفسه الذي فيه نتجمّد، هذا يعني أن الله موجود. فالأجدر بنا أن نفرح.