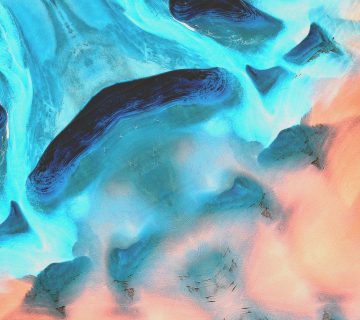كان حرف ال T دائماً الأكثر مراوغة. لا أعرف إن كان ذلك بسبب صعوبة تمييزه من قِبل طفلة عمرها خمس سنوات أم أن شركة ماجي تقتصد من الحرف عمداً؛ ربما كان لصاحب الشركة أكثر من حبيبة سابقة يبدأ اسمها بحرف ال”ت” ولم يعرف كيف ينتقم منهنّ سوى عبر الانتقام من الحرف.
المهم أن ضياع الحرف بين زحمة الأشكال والنشا كان يؤدي كل مرة إلى العراك نفسه:
- تالا الأكل مش للعب، خلصي أكلك.
- ماما، شبعت…
لم أفهم، أليست أمي التي توبخني لأنني “ألعب” بالأكل هي نفسها التي شجعتني أن أتخيل الملعقة بالوناً طائراً يحمل ألواناً ستنمو في بطني؟ أليست هي التي علمتني كيف أرسم بحيرة من الملوخية تعوم فيها بجعات من الأرز الأبيض؟
هي التي فتحت هذا الباب، ولكن يبدو أنها وقعت في الفخ الذي تقع فيه جميع الأمهات حين يعجزن عن التحكم بفتحات الأبواب. يردنها مفتوحة بقدر، فيصرفن نصف عمرهنّ بين الغلق والفتح وهن يحاولن إيجاد حلول وسطى. يستعنّ بالصدادات حتى يصل غضبهنّ أقصاه فيوصدن الأبواب جميعها بالشمع الأحمر. وهذا بالضبط ما حصل مع أمي ذلك الصباح المشؤوم عندما قرّرتْ أنّ تحويل المائدة إلى مسرح إبداعي لم ينجح في تحفيزي على الأكل.
صحوتُ باكراً مفتقدة رائحة الخبز المحمّص وصوت غليان إبريق الشاي الذي اعتدتُ أن ينبئني بحلول يوم جديد. اعتقدتُ أن مكروهاً ما حلّ بأمي، فهي لم تكف يوماً عن روتينها الصباحي. هرعتُ إلى غرفتها، فلم أجدها. توجهتُ إلى المطبخ فوجدتها جالسة حيثما تجلس كل صباح لتحل الكلمات المتقاطعة في الجريدة، إلا أنها الآن تقرأ القسم السياسي الذي لم تحتفظ به يوماً سوى لتلميع الزجاج.
- صباح الخير ماما
- صباح النور، غسلي وجهك وسنانك وتعالي افطري
أشارت بطرف عينيها إلى طبق يحتوي على نصف رغيف مقفول. ما هذا الجمود؟ لم أعتد هذه النبرة الجافة. أين صحون الزيت والزعتر التي أعتدتُ أن أُغمّس فيها رقائق الخبز المقرمش مُتخيّلة إيّاها دلافين تسبح في الماء لتنقضّ بعد ذلك على أسماك صغيرة من السمسم؟ أين كوب الشاي الذي أشرفتُ على تذويب السكر فيه قبل تقديمه لأمي، لأصنع موسيقى من طرق الملعقة بطرفه، مُتصورةً البلورات البيضاء سُحُباً رعدية؟
لم تنجح خطتها بالترهيب. قضمتُ لقمة من ذلك الرغيف الحزين وأقسمت بالله العلي العظيم أن لا أخضع لهذه المذلة. كان رطباً، مائعاً، لا يعلم إلى أي مجموعة غذائية ينتمي، وغير قادر على فصل نفسه عمّا فرشوه في داخله، فاختلط عليه الأمر وتداخلت مسامه بالشيء الأبيض المدهون فيه. لبنة؟ جبنة؟ الله أعلم.
تكرّر المشهد عند عودتي من المدرسة. بالعادة، تفوح رائحة الغداء إلى الخارج لدرجة أن صبري وعبلة، صديقيّ اللذين يجلسان إلى جانبي في باص المدرسة، يُخمنّان معي ماذا تكون الطبخة.
- شكلك رح تاكلي هوا اليوم.. ههه
أحبُّ عبلة جداً ولكني لا أطيق نكاتها السمجة في الأوقات العصيبة وأكره غيرتها عندما تنقلب ضدي.
عندما أُخبرها عن مغامراتي مع الطعام والشخصيات التي تزورني من داخل الأطباق، كنت أرى الحسد على وجهها الصغير يُحمّر وجنتيها ويعقد حاجبيها. وذلك أمر متوقع كونها من الفتيات اللاتي ولدن لأمهات لا يكترثن بالأبواب لأنهنّ قررن منذ اللحظة الأولى استبدالها جميعاً بجدران خرسانية. ولذلك، من المتوقع أن تكون عبلة أسعد خلق الله عندما أخبرها بمنهجية أمي الجديدة. كان علي ألا أخبرها. أحاول ألا أفشي مآسي حياتي لها ولكني أعجز عن إخفاء أي شيء عنها .
دخلتُ المطبخ الذي تحوّل بين ليلة وضحاها من سيرك إلى مأتم، فوجدتُ أمي على الكرسي ذاته تقرأ الجريدة أمام الرغيف المقضوم، وكأن الزمن لم يتحرّك منذ الصباح سوى ليقلب الصفحات من السياسة إلى الوفيات. ثم فجأة:
- بتعرفي انو في ملايين الأطفال بافريقيا عم بموتوا من الجوع؟ وحضرتك قاعدة بتتدلعي. بدك اتكملي أكلك! من يوم وطالع ما في لعب وما في دلع.
كشفتني! ربما أخذها وقتاً أكثر من اللازم ولكنها وأخيراً عرّتني، عرفت أنه رغم صغر سنّي لم ولن أخضع إلى أسلوب الترهيب والترغيب. أما تأنيب الضمير،فشيء آخر.
تخيلتُ أطفالاً أفارقة يحيطون بي ويشيرون بأصابعهم نحوي، بينهم فتاة بعمري، تُشبهني، ولكن ببشرة داكنة وقفص صدري بارز. تنظر إليّ، أو بالأحرى تنظر إلى رغيف الخبز ومن ثم إليّ وعيناها تتأرجحان بين العتب والاستفهام. أنستني قسَمي وأكلتُ الرغيف في دقيقتين، كاسرة الرقم القياسي لوجبات تستغرق ساعات، ولكن ليس بعد ذلك اليوم.
وكأن تحديثاً ما أصاب خوارزميات حمضي النووي، تحوّلتُ منذ تلك اللحظة إلى طفلة تأكل الأخضر واليابس، تصطحب معها إلى المائدة وقار جدتها التي تخصص طبقاً فارغاً للمسيح الذي تؤمن أنه يأكل في وسطنا. أما اللعب، فلم أجرؤ حتى على التفكير به؛ تجرَّدتْ الملوخية من بجعاتها لتصبح سائلاً أخضر ذا فوائد غذاية. أما شوربة الماجي، فهي ماء ساخن عليّ شُكر ربي مئة مرّة عليه:
- شكراً يا يسوع على هذا الطعام الذي أعطيتنا اياه رغم أن الكثيرين، خاصة في أفريقيا، محرومون منه. ساعد يا رب المحتاجين. آمين.
لم تكن أمي مُتديّنة، فهي نادراً ما تصلي أو تزور الكنيسة، لكنها منذ ذلك اليوم بدأتْ تردد هذه الصلاة قبل كل وجبة كأسهل طريقة لإبقاء ضميري صاحياً.
علّمتني الصلاة وصرتُ أرددها لوحدي حتى أصبحتْ الرقابة رقابة ذاتية أمارسها على نفسي، لدرجة أن شُرطيّة الأكل لم تعد تكترث بالجلوس معي إلى حين انتهاء الطبق كما كانت تفعل. الآن بإمكانها زيارة المرحاض أو إجراء مكالمات هاتفية خلال الوجبات.
كان المفترض أن أكون سعيدة بما أعطاني يسوع، ولكني كنت محتارة جداً وحزينة. لماذا يا يسوع تعطيني وتحرم أصدقائي الأفارقة؟ لم أفهم، ولم أستطع إلا أن ألحظ، مع مرور الوقت، اكتسابي المزيد من الوزن مقابل ظهور المزيد من أضلع صديقتي الافريقية التي رافقتني كل مكان بعينيها الدامعتين ووجهها المُتسخ. فبدأ ضميري يؤنبني على الطريقة التي أريح بها ضميري المؤنب، وهكذا بدلاً من إسكات الضمير، تضاعف الإشكال وأصبح لدي ضميرين لا أعلم أين أذهب بهما. آخ لو كان بإمكاني أن أرسل بعضاً من الطعام إلى أفريقيا.
ولكني لا أعرف أي شيء عن أفريقيا سوى أنها تحتوي على مصر، وصبري مصري، و أم صبري ستصطحب صبري معها في زيارة إلى مصر في آخر الأسبوع!
—-
في المرة الثالثة، طرقتُ الباب بتوتر شديد. أين أنت يا صبري، ألم نتفق أن تلقاني أمام الباب عندما تسمع طرقة واحدة خفيفة؟
الطرقة الخامسة. أسمع صوت خُطى أقدام. هيا يا صبري، ليس لدي الصباح كله. ستصحو أمي وتكتشف تسللي من البيت.
فُتح الباب ولمُفاجأتي لم يكن صبري.
- تالا؟ بتعملي ايه هنا والساعة لسا ٦ الصبح، في حاجة يا حبيبتي؟ انت كويسة؟.. إيه الكيس الإسود ده؟ في ايه يا حبيبتي؟ وإيه الريحة دي؟
تمنيتُ لو كانت الأرض رمالاً متحركة أغوص فيها وأختفي عن وجه هذا الكوكب. ماذا عساي أقول لأم صبري؟ “أريد أن أرسل مع ابنك أكلاً كان من المفترض أن آكله لكي يُسلّمُه إلى أصدقائي الأفارقة”؟ لا أخجل من مبادرتي التي أعتقد أنها الحل الأمثل للمشكلة ولكن همي أن أخفي الأمر عن أمي. لا يجب أن تعرف أني كنت أعرض عليها ماءً كثيراً قبل الغداء فقط لكي تضطر إلى الذهاب إلى المرحاض حتى تُتاح لي فرصة تجميع الأكل في كيس أسود خبأتُه تحت الطاولة.
- صباح الخير آنتي. وين صبري؟
- صبري نايم
كان عليّ أن أعرف أن نومك ثقيل يا صبري، ثقيل جداً. مثلك ومثل العالم كلّه الآن. أدخلتني أم صبري إلى الصالة واتجهت نحو المطبخ لتجلب لي كوباً من الماء، وعندما عادت قالت:
- مامتِك مستنياكي في البيت. قلتلها انك هِنا وطمنتها عليكي علشان ما تقلقش
الله عليكِ يا ام صبري، الله على قلبك الحنين اللي هيوديني في داهية!
خلال عودتي إلى البيت الذي كان يبعد عن بيت صبري شارعاً واحداً فقط، فكرّتُ في الهروب إلى مدينة بعيدة لا يعرف عنها أحد. ولكن ضميري كعادته، كان صاحياً، ساق قدميّ نحو المنزل دون أي اكتراث لأفكاري.
تسللتُ إلى البيت محاولة الوصول إلى غرفة نومي دون التعاطي مع أحد، ما أجبرني على المرور من أمام مطبخنا الذي وجدتُ فيه أمي جالسة في كرسيها ذاته، تقرأ هذه المرة النشرة الاقتصادية.