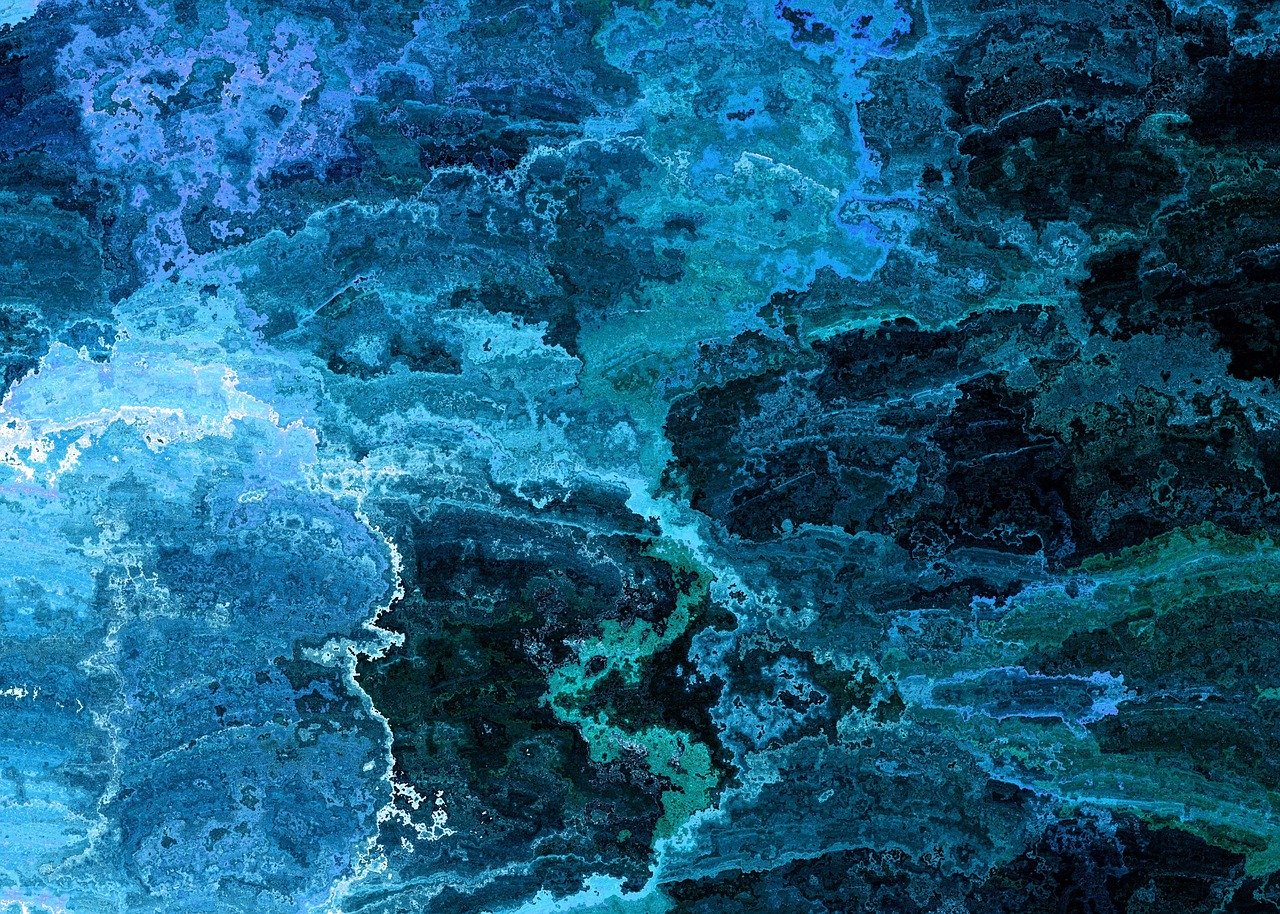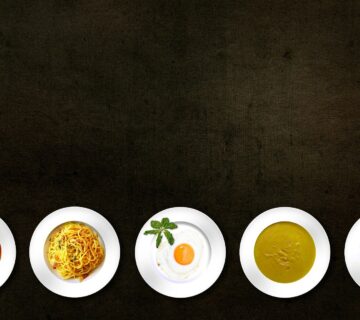لم أرَ يوماً أمي وهي تبكي، أمامي على الأقل. اعتقدتُ أنها لم تبكِ حتى في الخفاء، فجميع المرات التي تقمصتُ فيها شخصية المُفتش الفضولي الذي لا يرحم، لم أستطع أن أجد لها أثراً منسياً واحداً كانت قد تركته بعد ليلة رثائية، كمخدة مبلولة أو محارم ليس لها أي تبرير مكدسة في القمامة.
كنت أفتش لأنني أردتُ أمي أن تبكي. أردتها أن تبكي ليس لأنني لئيمة، بل لأنني كرهت الشتاء. سأشرح لكم الأمر. في ذلك الوقت كنتُ مقتنعة أن الله يوزع علينا البكاء كل واحد حسب ما يستدعي أمره. ولأنّ أمي كان لها ألف سبب وسبب لكي تبكي، كان يحق لها أن تبكي لترين في الأسبوع الواحد. وبما أنها لم تستهلك أي منهم، على الأقل منذ أن بدأت عملية البحث قبل قرابة عامين، فأصبح لدى لله 192 لتراً من المياه لم تُذرف منهم دمعة واحدة. فائضاً كهذا كان لا بد من التخلص منه، ولذلك قرّر الله أن يسكبه من السماء. نعم هكذا يتكون الشتاء، لم أقتنع يوماً بتحليل معلمة الأحياء التافه القائم على معتقدات غريبة كالتبخر والتكاثف، وكلما سَخِرَت من فكري المستقل، كلما زاد عزمي على إثبات النظرية. إذن أردتُ أمي أن تبكي، أولاً لكي يتوقف الشتاء الذي لم يترك سماء المدينة منذ عامين متواصلين وثانيّاً لأنني راهنت معلمتي الحمقاء، أن الشتاء سيتوقف حالما تذرف أمي حصتها من البكاء.
اتضح لي مع مرور الوقت أنّ السبب وراء عدم بكاء أمي هو حبها للشتاء، فما الذي قد يعيقها غير ذلك؟ خاصة أنها لم تتذمر يوماً بشأن المطر. سئمت من كل هذا، حتى أني أوقفت حملات التفتيش، إلى أن أتى ذلك اليوم المشمس الذي هرعت في صباحه إلى غرفة أمي لأتفقد كل ركن. بحثت تحت السرير وفي سلة المهملات وفوق الخزانات ولخيبة ظني لم أجد شيئاً. تحسست وجهها، وتفحصت عينيها لأجدهما مقفرتين كصحراء لم تطأها قطرة مياه واحدة. بدل من التمتع بالشمس العذبة والنسيم الذي عاد إلى مدينتنا بعد طول غياب، تمنيت لو عاد الشتاء حتى لا أضطر أن أشهد تحطم كبريائي أمام معلمة الأحياء التي أتتني خلال الاستراحة لتقول لي: “شو يا تالا، مش مستمتعة بالشمس الحلوة؟ ليش زعلانة، يمكن عشان امك كانت عم تبكي ولا شو؟”.
قتلتني برودة أًعصابها، وخجلتُ من كبريائي الذي رأيته يتحطم قطعاً صغيرة من المستحيل إعادة لصقها.
تكررّ المشهد كلما شرّفت الشمس التي لم تعد ضيفة شرف بل أصبحت ركناً أساسيّاً من معالم المدينة. وبعد تفحص حثيث لغرفة أمي والبيت كله في الأيام المشمسة الأولى، استسملتُ للأمر الواقع واقتنعتُ أخيراً أن أمي لم تبكِ في حياتها ولن تبكي أبداً.
الغريب في الأمر أنه رغم تشابهنا أنا وأمي في أمور كثيرة، إلا أننا وصلنا إلى مفترق طرق عندما كان يحين وقت البكاء. فأنا لا أبخل على نفسي ولا أهدر قطرة واحدة من النصف لتر الأسبوعية التي خصصها الله لي. في البدء كان لدي مشكلتين اثنتين تدفعانني للبكاء: أولاً أن أمي لم ولن تبكي، وثانيّاً أنه ليس لدي ما يكفيني من الرصيد لكي أبكي براحتي. ولكن أُضيفت إليهما مشكلة ثالثة عندما كنت في الثالثة عشر من عمري، وكانت صديقتي عبلة قد سرقت مني حبيبي الأول، الذي لم أتكلم معه مرة واحدة ولكنه كان محسوباً عليّ. وكانت عبلة تعلم ذلك جيّداً. بكيت لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، انهمرت مني الدموع بمجد غير مسبوق خاصة وأن أحداً لم يكن في البيت. تعمدتُ على غير العادة، أن أُخفي بكائي عن باقي أفراد المنزل، خوفاً من أن أصبح محطّ شفقة أو سخرية، الأمر الذي كان من الممكن أن يُحوّل ما تبقى من شظايا كبريائي إلى فتات. انقطع بكائي فجأة عندما سمعتُ طرق المفاتيح بالباب. لم أتوقع عودة أمي بهذه السرعة. ارتبكت، كان عليّ أن أمحي أي أثر لهذه المناحة التي خلّفت وراءها وجهاً أحمراً احمرار الطماطم، وعلبتي محارم متناثرة على أرض الغرفة.
دخلت أمي على غرفتي. كنتُ قد وضعت المكياج وتخلصتُ من المحارم. لم تلحظ شيئاً. افتخرتُ من احترافي ومهارتي في إخفاء الفاجعة إلى أن رنّ جرس الباب. استقبلتُ جارتنا أم سمير التي كانت تقطن في الشقة الأرضية تحت شقتنا. لطالما أرعبتني بشعرها الأشعث ومزاجها العكر وقطتها السواداء “كليوباترا”، ولكن كل هذا لا يُقارن بعقدة حاجبيها وحملقتها الثاقبة التي اخترقتني عندما فتحت ذلك الباب اللعين.
“كليوباترا ماتت. ماتت كليوباترا. بتعرفي كيف ماتت؟ بلعت المحارم اللي وقعوا عليها من شبّاك حضرتك”. رغم محاولتي في تشتيتها، أتت أمي فور سماعها صياح أم سمير. تيقنت أنها ستغضب مني وتكشف سري. “شو في أم سمير. مالك؟”. “بنتك يا ستي من أول ما طلعت الشمس وبلّشنا نقعد برّا بالجنينة وهي بترّمي علينا محارم، أول مرة سامحناها، تاني مرّة قلنا مش مشكلة، البنت صغيرة. تالت، رابع، خامس مرة، ماشي. بس تقتلي كليوباترا؟ كتير هيك.”
نظرتُ إلى أمي، التي نظرت إلي بخجل، مُحاولة بدورها أن تُشتتني.