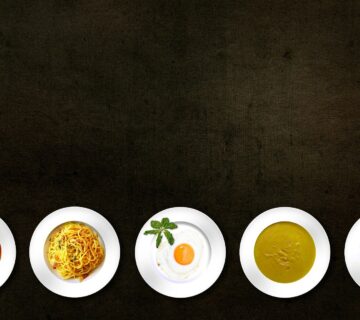رأيته هناك عند التقاء زوايا السقف. عملاق قد شدّ الرحال نحو غرف الأطفال التي هجرَتها جميع الأصوات والأنوار باستثناء صرير الليل وبعض الإشعاعات الخافتة. غرفٌ مثل غرفتي، وأطفال مثلي. قد سبق وأخبرَتني صديقتي عبلة أنني لن أفلت من قبضة “أبو شاكوش” وإن لم تهددني معلمة الأحياء به كما كانت تهددها هي نظراً إلى سوء تصرّفها في الصف. لم أصدقها ولكن ها هي على حق.
هرعتُ إلى أمّي التي كانت قد جلست لتوّها أمام التلفاز. كانت هذه ساعتها الوحيدة التي حظيتْ فيها بشيء من الراحة قبل أن تقود هي الأخرى جسمها المنهك إلى النوم. لم نفكر مرتين أنا وإخوتي قبل أن نُقحم أنفسنا على مساحتها الخاصة عندما كان يستدعي الأمر إلى ذلك، فأمور كشرب الماء والتبول، إضافة إلى أحلام يقظتنا وأحلام مناماتنا كانت كلها أموراً طارئة تستحق أن ننزع من أمي سكينتها الليلية. ما بالكم عملاقاً يغزو غرفتي؟
“ماما. أبو شاكوش بدو ياكلني” شكيتُ لها باكية وأنا أُمسكُ بطرف قميص نومها الذي بات مهترئاً من كثر الشد والسحب. “ما تخافي يا قلبي، فرجيني ياه وأنا رح أتصرف”. كانت دائماً تأخذ كلامنا الإعتباطي على محمل الجد، لم تُشعرنا يوماً أننا كأطفال نفتقد القدرة على تحليل الواقع بشكل “صحيح”. على العكس، كانت تحب الإصغاء إلى تحليلاتنا، حتّى أنني أعتقد أنها قد اقتنعت ببعض منها. مسكَت بيدي ومشينا بحذر نحو غرفة النوم. لم أتجاوز، من خوفي، باب الغرفة وفضلتُ قابعة عنده أُدلي بإصبعي نحو أنياب العملاق التي بانت الآن أكبر مما كانت عليه عندما غادرتُ الغرفة. لم يكن هذا الاختلاف الوحيد، فيبدو أن تعزيزات قد أُرسلت لمد أبو شاكوش بعفاريت ووحوش ومتاريس وسيوف وعربات نارية كلها مُتجهة نحو سريري الفارغ.
زاد خوفي كما قبضتي على يد أمي التي راحت تقودني ببطء نحو السرير. أردتُ مقاومة السير ولكني في الوقت نفسه وثقتُ بأمي التي أثبتَت مواقفاً عديدة سابقة أنها تتحلى بقدرة سحرية على تبديد الخوف مهما كان كبيراً. وكأنها أحسّت بخوفي يتصاعد، رفعتْ الغطاء فوق رأسينا سرعان ما وصلنا إلى السرير. تمنيتُ ألا يخترق لهاثي وكرنا الصغير فينكشف مخبأنا. حاولتُ أن أصغي إلى ضربات قلبها الهادئة علّها تزوّدني بعضاً من سكينتها فأضبط نفسي وفقها. “ششش… ما تخافي حبيبتي” قالت لي وهي تضمّني وتمسّد شعري. “هاي العفاريت رح تختفي أول ما تشرق الشمس، ومن هون لوقتها رح نلعب لعبة”. رفعتْ يدها وأشعلت مصباحاً يدوياً كانت قد اصطحبته معها قبل أن ندخل إلى الغرفة. ارتبكت. ما الذي تفعله؟ كيف لها أن تقود العفاريت إلينا بهذه البساطة؟ لولا إيماني الأعمى بها لكنت قد شككتُ بأنها عميلة تَسلّمت مُهمة قتلي. أغمضتُ عينيّ وانتظرتُ أن ألقى حتفي إما هرساً بين أضراس العملاق أو دهساً تحت عجلات العربات النارية.
“تالا فتحي عيونك. اتطلعي”. نظرتُ إلى الأعلى عبر الغطاء لأجد عصافير تُحلّق في الأفق. عصافير ومن ثم غزلان وأرانب وقطط. “هاد اسمه ظل” قالت لي وهي تضحك مشيرة إلى حركة أصابعها التي كانت تستحكم بالأشكال المرسومة على الحائط. كانت المرة الأولى التي أسمع فيها عن الظل. سعدتُ بوجود عالم بأكمله لم أكن أعلم بوجوده. قلدتُ انحناءات يديها وخلقنا سوياً بساتين وقصور، أمراء وأميرات أمضينا الليل بطوله ونحن نرسمهم ونحيك قصصهم. لولا آذان الفجر الذي تسرّبت أصدائه من النافذة، لما توقفنا عن الحلم والقصّ. ردّنا التكبير إلى الواقع، فتثائبت أمي واستعجلت نحو الختام: “وتوتة توتة خلصت الحتوتة. شو رأيك نرفع الغطا ونشوف شو صار بأبو شاكوش؟”. كنت قد نسيتُ السبب الأساسي الذي بفضله استكشفتُ عالماً بأكمله يكمن بين أصابعي. حدقتُ في السقف حيثما كانت الوحوش مزدحمة لأجده أبيضاً فارغاً. لم أصدق ما حصل، أشعلتُ المصباح ثانية لأبحث عن الغزلان والبساتين لأجدهم هم أيضاً قد اختفوا عن الأنظار. لاحظتْ أمي حيرتي وأسئلتي التي شعرتُ بها تتدفق منّي لصعوبة احتواء كثرتها، ولكنها لم تساعدني على فهم ما يدور في خاطري، كل ما ردّدته بنبرتها الحنونة: “مش قلتلك رح تختفي العفاريت أول ما تشرق الشمس؟”.
—-
بعد أن كبرتُ اضمحلّت مخاوفي. تفتّتت إلى جزئيات لا يُمكنني رؤيتها بالعين المجرّدة حتى بتّ لا أخاف “شيئاً”. ولكن هذا لا يعني أن الخوف قد هجرني، على العكس، زادت وتيرته وتفاقمت زياراته. صحيح، أن لا شيء يخيفني ولكن هذا فقط لأني لا أعرف ممّا أخاف أو مِن من. لم يعد الخوف متركزاً أو مُتكوّماً في أشياء معينة يمكنني الإشارة إليها؛ لم تعد الأشياء هي التي تحتوي الخوف بداخلها، بل أصبح الخوف هو الذي يحتوي لا شيء وكل شيء في آن واحد. فقط أشعر بالخوف يلاحقني وينقض عليّ بحرب عصابات يصعب عليّ مواجهتها أو الهرب منها لكثرة تبعثرها. بينما كانت مخاوفي و أنا صغيرة بمثابة سرطان رئة تستأصله أمي كل ليلة قبل النوم، أصبحت اليوم بمثابة سرطان دم يصعب تعقبّه أو مُلاحقته.
أتمنى لو أستطيع أن أُفلتر خوفي اليوم وأرّكزه في أبو شاكوش آخر علني أستطيع مواجهته أو تجنبه، ولكن في الوقت نفسه أعي أن هذا ليس بالضرورة هو الحل. ما زلت أذكر عدم اكتراث أمي بالإنقضاض على مخاوفي تلك الليلة عبر فتح الضوء أو إغلاق الستائر؛ كل ما فعَلته هو أنها ألهتني عنها، انتظرت معي، وأكدّت لي بأنها ستزول.